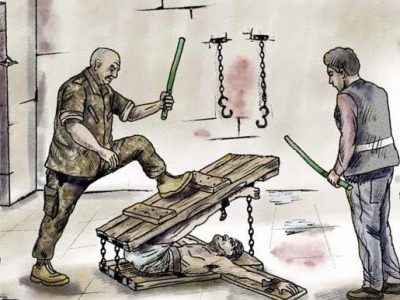أتى فصل الشتاء القارس هذا العام على كلّ ما يُوقد، سائلاً كان أم يابساً، والعاصفة الثلجية تحكم الحصار منذ ثلاثة أيام، قضت على ما تبقّى من ذخائر ومؤن! باستثناء قليل من حبات البطاطا والبصل وبعض أرغفة خبز يابس!.
العاصفة تشتدّ، والزمهرير يزداد هياجاً، وعُواء الريح يعلو، ولسعات البرد أصبحت أكثر إيلاما.
وأمام النافذة، قبيل هبوط الظلام، وقف أبو علاء ينقّل أنظاره ما بين أولاده المتراصّين جنبا إلى جنب، مدثّرين ببطانيات رقيقة، وبين السماء الداكنة المكفهرّة، التي ما انفكت ترمي ندف الثلج بغزارة دون توقف، كأنما تفرغ جام غضبها على المكان أو على أهله، وربما على كليهما معا! فيتمطّى الغول الأبيض ويتعاظم ثقله على صدر البلدة، حابسا أنفاسها، قاطعا جميع طرقاتها، وقاطعا الأمل من فَرجة وشيكة!.
وبين حين وآخر، كان المسكين يلقي إليها نظرات حزينة حنونة، فقد أحبّها وربّاها، يوما بعد يوم ورعاها كما يرعى أولاده، فكانوا يكبرون وتكبر معهم!. مكتبة قيّمة، منوّعة، فيها كتب تاريخ وسياسة واقتصاد، كتب فقه ودين وتراث، كتب أدب وتراجم ونقد، كتب شعر وقصة ورواية، كتب قومية واشتراكية وعلمية وغيرها. وحين أمعن النظر في وجه صغيرته الُمدلّلة المزرقّ من شدِّة البرد ورأى يديها المرتجفتين حسم أمره بسيف قراره القاطع والحاد، فوضع عدة صحف ومجلات في موقد الآجر، فاغر الفم، القابع في زاوية الغرفة، ثم أشعل عود كبريت ورماه عليها، وحين اضطرمت النار راح يصلي الكتب واحدا تلو الآخر، ولم يستمع لاعتراض أم علاء، وربما لم يسمعه، فقد كان يصغي إلى عواء الريح الممطوط المريع، عبر شقوق الباب، منذرة باجتياح الغرفة! فقام وأحكم إغلاق الباب جيدا.
في البداية، كان يختار وجبة الكتب التي سَيُقريها للموقد، ثم يرميها في فمه بسرعة من غير مبالاة، بعدها راح يتأمّل بعض الكتب، يُقّلبها بين يديه، يتصفّح بعضها، يهزّ برأسه، يبسم بسمة حزينة، وترتسم على وجهه أمارات مختلفة، لكنه سرعان ما أحجم عن ذلك، وراح يُطعم النار أيّما وقعت عليه يداه، من غير أن ينظر إلى الكتاب، خوفا من أن يرى علامات الرعب على وجهه، أو يسمع توسلاته أو استغاثته فيشفق عليه، ” لا عين تشوف ولا قلب يوجع “، فقد أحسّ كما لو أنه يُطعم الموقد من لحمه. لا بأس! .. وهل كان يبخل بلحمه من أجل فلذات كبده!؟.
تأججت النيران في الموقد، وراحت الكتب تحترق فرادى و جماعات، فهذا كتاب يشتعل، يحمرّ، يغدو كالجمر، ويدوم لظاه مدة غير قليلة، فيبعث أُوارُه الدفء في أركان الغرفة، وفي الأجساد الصغيرة الجامدة الذاوية، التي دبّت فيها الحياة والحركة من جديد. وهذا كتاب يحترق، يُفرقع، يُدخّن، ينثر شرارات تلسع الأيدي والوجوه، وسرعان ما يخمد ثم يهمد من غير ما دفءٍ أو لهبٍ أو ضوء!. وذاك كتاب يشتعل، يَسعُر، ويرسل ألسنة لهب سنيّة، تتراقص وتتمايل وتلمع وتبرق بألوان جميلة أخّاذة، صفرٍ وحمرٍ وخضرٍ وزرق، فتبعث السرور والبهجة في القلوب وترسم الفرحة على وجوه الصغار، وقد راحوا يتضاحكون ويطلقون عبارات التعجّب وصيحات الابتهاج وهم يلاعبون النار ويشاركونها في رسم الظلال المتحركة الساحرة الممتعة على الجدران.
أمست السهرة رائعة لا تنسى، حفرت في ذاكرة الأولاد، تناول خلالها الجميع البطاطا والبصل المشويين والخبز المحمّص واحتسوا أثمن وألذّ شاي في العالم! أُعِدّ على نار الفكر الوقّاد، واختمر على حرارة المعرفة المقدسة!.
وكان الكتاب الأخير، كبيراً، ثقيلاً، سميك الجلد، وحين ألقي به وسط المعمعة أخذت النار كأنما تعسّ فيه ببطء، ثم انبعث منه دخان كثيف أزكمت رائحته الأنوف، وملأ الغرفة والصدور، فخمدت النار وهمدت حتى انطفأت! .. ولم يعد أحدٌ يرى أحدا، كما لم يعد يُسمع سوى تناوب موجات سُعالٍ شديد، وعُواء الريح المَمطوطِ عبر شُقوق الباب!.