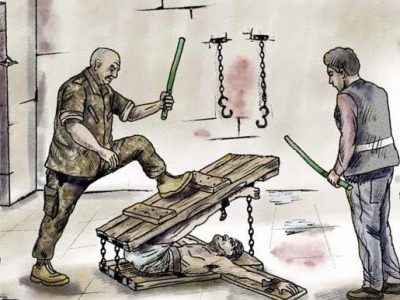كانت صورة الشّلّال، المشهد الذي راقبه، لسنوات، في هدوئه العذب، ترجع إليه، ضبابيّةً، بعيدة، شيءٌ ما يبتلع نتوءاتها، ويطغى على تفاصيلها. وعبثاً وجد طريقة ليعود إلى المكان، منذ الحادث، تحوّلت حياته، إلى سلسلة عمليّات، تركيب وتثبيت وترميم، دون أن يعرف أطبّاؤه، على وجه الدّقّة، ما سينجحون في بعثه، من كومة العظام المفتّتة.
كلّ ما لديه الآن، يدٌ سليمة، مرسَمُه، ألوانه الزّيتيّة، وتوقٌ يائس، لبعث المشهد الأثير، ولذا، وبرغم جنون الفكرة التي راودته، لم يتردّد في طرحها توّاً، عندما زاره قريبه، الجنديّ السّابق الذي اقتلعت الحرب عيناه. كان الرّسّام يائساً لإعادة فتح النّافذة التي تطلّ منها عيناه على العالم الوحيد الذي يحبّه، ماذا إذاً، لو يضع عينيه في هذين المحجرين الفارغين، لبضع ساعات فقط، في زيارة سريعة للشّلّال موضوع لوحاته؟
يداه اللّتان تتحسّسان نتوءات الأسطح، تقرآنها، كانتا ترتجفان، عندما حطّتا على وجه الرّسّام العاجز، وغمرت، جلدهما الخشن، رطوبةٌ نديّة، انسكبت من الحدقتين.
شفقةً على قريبه الفنّان، وإمعاناً في فعلٍ، لم يقم به منذ سنوات، لم يعد يحصيها، عاد الرّجل في اليوم التّالي، تناول العينين التوّاقتين، ثمّ هرع بنظّارته المعتادة، وعصاه البيضاء، يقطع الدّروب، وصولاً إلى وجهته المقصودة.
النّور الذي كان بالأمس فقط، ظلاماً دامساً، ها هو يخترق عزلته، يخترق كلّ ذرّة في كيانه، ويتركه مبهوراً مسلوبَ الأنفاس، ياه، هل يتذكّر المبصرون كم هو مدهشٌ النّهار؟!
فعل كما طُلب منه، بقي لساعات، يعاين الشّلّال الوحيد، من كلّ زاوية وكلّ جهة، تلتقط العينان كلّ تفصيل؛ القطرات المتراكضة، الأزرق الحادّ، الزّبد الأبيض، الخضرة في كلّ ما حوله، الطّحالب، زنابق الماء، الأزهار، السّحالي الصّغيرة..
قطعةٌ من الفردوس! فكّر الرّجل، وتدحرجت نقطتان مائيّتان من العينين الدّخيلتين في المحجرين؛ كيف لا يؤخذ الإنسان بالجمال؟!
لوهلة، شعر بحسدٍ إزاء قريبه الذي أمضى جلّ عمره في هذا الجانب من الحياة، الجانب شديد البهاء.. وتلبّسه، في تلك اللحظة، حنينٌ هائل، إلى رؤية عالمه الخاصّ الذي أمضى فيه، هو، جلّ عمره، والذي اعتقد دوماً، أنّ له جانبه الخاصّ من البهاء أيضاً.
في طريقه، بدت الشّوارع مألوفة، لم تتغيّر الدّنيا كثيراً في سنوات عميّه، حمل ذلك بعض الطّمأنينة إلى قلبه المهتاج بإثارة الرّؤية، لكنّ طمأنينته لم تدم، إذ أنّه، متى نقر الأرض بعصاه، كان النّاس من حوله يتطلّعون إليه مستكشفين، يحملقون فيه طويلاً، دون حياء، كما لو كان حيواناً في السّيرك، وكانت النّساء يبعدن صغارهنّ عنه، كما لو كان مصاباً بالجذام، والرّجل الذي كان يعدّه صاحباً له، حرص، عند المرور بقربه، على إطباق فمه، فلا يتعرّفه.
أثار كلّ ذلك، انفعالاً عنيفاً في نفسه، هارباً من اضطرابه، سارع خطاه باتّجاه حيّه، لكنّ، مفاجأة أخرى لم يكن يتوقّعها، كانت هناك تنتظره، إذ عند مدخل الزّقاق إلى بيته، كانت مجموعة أولاد، متراصّين قرب الجدار، يترقّبون شيئاً، ميّز وجوه بعضهم عندما كانوا صغاراً، وأدرك، كانوا ينتظرونه هو، وكانت هناك، تماماً أمامه، حجارةٌ دخيلة، لا بدّ أنّهم وضعوها هناك، متعمّدين.
جاراهم، وضع طرف قدمه فوق الحجارة، وكاد أن يهوي، تسارعت الأيادي الطّريّة لتعلو الأفواه في محاولة لعدم انكشاف فعلتهم، بينما راحت الأجساد الصّغيرة تهتزّ نشوة.
عاودَتْه، كلّ المرّات التي تعثّر فيها من قبل، في هذه البقعة عينها، لم ينطق، وهرول، بقلب منتفض، إلى المكان الوحيد الآمن، إلى بيته.
زوجتُه في المطبخ، منهكةٌ في الواجبات، نقيّة جميلة، رغم تعبها الواضح، والزّمن الذي رسم خطوطاً دقيقة حول فمها وعينيها.
هدّأت رؤيتها من الآلام في صدره، وشدّته لهفة لعناقها، لإخبارها أنّه يراها، يحبّها، ويقبّل كلّ نقطة ذهبيّة في عينيها.. راح يقترب بجسده الضّئيل، عندما لفحَته، نظرةٌ حادّة، نظرةٌ تشوبها قسوة جارحة، أو لعلّه عذابٌ دفين، لم يعلم على وجه اليقين، لكنّها نظرةٌ لم يعهدها قطّ، في تينك العينين الحبيبتين.. “دعني، أنا منشغلة الآن”، تبرّمت المرأة بصوت ضعيف.
أين ذهبت الصّبيّة العذبة؟ متى انطفأ فيها العطف؟ متى صار الحنو إلى بلادة؟ أسئلة كثيرة راحت، كحشدٍ من الغربان، تنقر رأسه المتعب وتعيد إظلام الدّنيا في وجهه.
تركها متوجّهاً إلى غرفة طفله الصّغير، “يا لوجه الملاك” قال في نفسه وهو يحاذي الباب، رمقه الولد بنظرة سريعة، نظرة لا مبالية فارغة، وتابع لعبه دون أن يعيره اهتماماً.
قد يكون من الصّعب توصيف ما اعتلج في نفس الرّجل في تلك الأوقات، وما جال في رأسه بالضّبط وهو يمشي، في الغسق المتثاقل، والسّواد يهبط من حوله، لكنّه، وباختصار، شعر بنفسه، شيئاً زائداً، غير مرغوب، غريباً في بيته، وحيداً في الدّنيا، لا أحد له، وشعر بحياته، تطفو فوق الرّيح، بأنّ العالم الذي لطالما عرفه، ولم يعرف سواه، يختلّ تحت قدميه.
هرع عائداً إلى قريبه الرّسّام، بوجهٍ شاحب ذابل، أعاد عينيه، ونقاط مائيّة كانت لا تزال تعلوهما.
“لن أكرّرها”. قال جازماً، ضرب بعصاه الأرض، ومضى.
أما الرّسّام الذي عادت له عيناه، وخلافاً لما توقّعه، لم يعد إلى محاولة نقل شلّال الحياة البهيّ، رغم امتلاكه ذاكرةً بصريّة مثاليّة له، لكنّه من يومها، ودون أن يدرك أحد السّرّ، بات يرسم لوحات كثيرة؛ صوراً لوجوه بشريّة، محجوبةٍ خلف طبقةٍ رقيقة من البلل، وجوهٌ، تبدو تائهة بعض الشّيء، وكليّة القسوة.