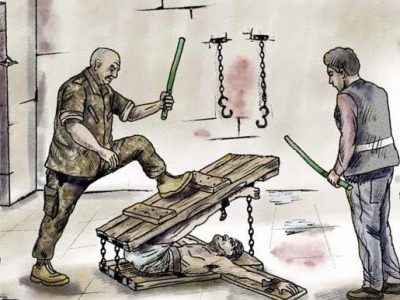القصة الفائزة بالمركز الثاني مناصفة في مسابقة أبجد.
– يردّدونَ دائماً على مسامعها بأنّ اسمها “كيوت” جداً، ويجبُ عليها أن تتحمّلَ مسؤوليةَ اسمها وأن يكونَ مظهرها ملائماً له، لكنها ترددُ -بدورها- على مسامعهم: أنا لا أحبّ الموضة.
– إذا كان هناك شيءٌ لا تحبه فلمَ عليها التصرفُ وفقَ ما يوحي أنه العكسُ؟! كلامهم غيرُ منطقيٍّ وهي إنسانةٌ منطقيةٌ وملتزمةٌ بقناعتها الخاصة: بنطال و”تيشيرت” في الجامعة، لا مانعَ من فستانٍ بسيط في المناسبات العائليّةِ، ولا بأس بتنانير الجينز في الأماكن العامةِ حيث تجتمع مع الأصدقاء.
– لا بدّ أن تتخللَ كلَّ جلسةٍ ولقاء آراءُ فاعلةِ خير ما -مع تغيرِ هويّتها كلّ مرة- وهي آراء من قبيل: “سمعتُ أولئك الفتياتِ في عيد الميلاد يتهامسن بشأن شعرك المجعَّد الذي لا تغيّرين تسريحتَه مهما كانت ملابسكِ”، أو “كانت سالي ستكتسحُ الساحةَ بسهولةٍ لو أنها اختارت نمطاً رائجاً ترتديه”، أما ردةُ فعل سالي فهي منطقيةٌ جداً: التجاهل، التجاهل فحسب.
– سالي فتاةٌ عصاميّة وتكره الاتّكاليةَ، إنسانة منطقية من جميع النواحي: دراستها، علاقاتها الاجتماعية، صحتها، إنها باختصار “روبوت” رقيقٌ وجميلٌ جداً -بشهادة الجميع- ذو قوام ممشوق ووجه حسَن، لكنه يكره الموضة، وبما أنها فتاة ذاتُ حسٍّ عالٍ بالمسؤولية فقد قررت أن تبحث عن عملٍ لأن الوضعَ المعيشي لأسرتها بدأ يتدهور شيئاً فشيئاً بسبب الغلاء الفاحش والحال الاقتصادية المتردّية.
– سالي تكره الموضة: هي لا تتبعها.
– سالي تحب المنطق: هي تستشيرُ عقلها في كل شاردةٍ وواردةٍ.
– سالي تعاني من المشاكل: هي تبحثُ عن الحلول وتصنفها بكل منطقيةٍ وفق إيجابياتٍ وسلبيات، وتفاضل وتقارن وتوازنُ.
– سالي تثقُ بأهمية الدراسة وضرورتها: هي من الأوائل على دفعتها في الكليّة.
– سالي تعاني مؤخراً من مشاكلَ مادية: فالحل المنطقي إذن هو البحثُ عن عمل.
– سالي تعملُ دون تكبّرٍ لكنّ ساعات الدوام الجزئي مهما كان نوعه لا يدرُّ عليها ما يكفيها أكثر من أسبوعين.
– سالي لم يعد أمامها إلا خيار واحد يؤمّنُ لها ما تحتاجُ إليه من مال: أن تعمل “مودل” لمنتَجات شركة ألبسة افتُتحت حديثاً.
– سالي صارت “مودل” لكنها بقيت تكره الموضة وتحبّ المنطق، ورغم ثباتها على مبدئها العنيدِ أمام نفسها وأمام الآخرين إلا أنّ الحمرةَ اكتست خدَّيها وازدادت ضرباتُ قلبها، وصارت أقل “روبوتية” و”كيوت” أكثر بشهادة الجميع.
-النهاية-
-“أحسنت، نقطتان أُخريان للفريق”.
كم أنت رائع يا صلاح! سوف نفوز بالتأكيد بعقلك الجميل هذا.
كنتُ أنا الناطقَ الرسمي باسم الفريق المكوَّن من: صلاح “الآلة الحاسبة” إلى يساري، رنيم “الآلة الصامتة” إلى يميني، وأنا “الآلة الناطقة في ذلك الوقت، الكاتبة الآن”.
مسابقةٌ في المعلومات العامة لطلاب الصف الرابع بين مدرستي ومدرسة ابتدائيةٍ أخرى، النتيجة حتى الآن مطَمئِنة، وإن حافظنا على المستوى ذاته فسوف نسحقُ الفريق الخصم ونهزمه شرَّ هزيمةٍ، أنظر إل عينَي جاد بكلِّ تحدٍّ وشراسةٍ، أيام الطفولةِ في الروضةِ بمغامراتها وجنونها لن تشفعَ لك الآن بعد أن كبرنا وأصبحنا في الصف الرابعِ، لن أتهاونَ معك يا جاد وسترى كيف سيفوزُ فريقي وأعود إلى مدرستي وأنا أروي حكايةَ النصر العظيم.
-“كم عضلةً موجودة في خرطوم الفيل؟”.
كانت هناك ثلاثةُ احتمالاتٍ وجميعها أعداد من خانة الأربعين، قالها الموجه -الذي كان يسأل- بتشفٍّ مخفيٍّ وكأنه يقول شامتاً: “انتهى أمركم، وخاصةً أنتِ أيتها الشقراء المغرورة”.
انتقل السؤال إلى الفريق الثاني بعد أن أخطأنا…لا أصدق، لقد فاز فريق جاد اللعينُ.
عدتُ إلى المنزل بقلب منكسرٍ وحقد طفوليٍّ ثقيل، لم أهتم لعباراتِ المديح التي رشقَتها المشرفةُ المرافقةُ على مسامع أمي بعد أن أوصلتني إلى المنزل: ” لقد كانت جريئةً وواثقةً وقائدة ماهرة”. ولكن خسرنا… نسيتِ أن تقولي هذا وهو الأهم.
أصبح الفيل عقدةً منذ ذلك اليومِ وخاصةً خرطومه القبيح، القبيح جداً.
-“انظري إلى صورة هذا الفيل الظريفِ بعينيه الزرقاوين، لا أفهم كيف أنك لا ترين من الفيلةِ إلا الخرطومَ، حتى هذا الخرطوم الذي تكرهينه هو أجمل ما فيها وهو ما يميزها”.
“هديل الفيل”؛ صديقتي الضئيلةُ بصوتٍ ناعم كاسمها، لم أعد أراها إلا فيلاً صغيراً لا خرطوم له، إنها صديقتي المقربةُ التي أحبها لذا محال أن أراها بخرطوم، منذ شهرين فحسب اكتسبَت هديل لقبها بعد أن شهدت كليّتنا غزواً فيلياً مقنَّعاً بالقمصان والستراتِ والإكسسوارات والحقائب، لقد جُنّت الفتيات يا ربي! أهذا الغزو المجنون في الكلّية يسمّينه آخر صيحات الموضة؟!
لا أدري لمَ مراحلُ نمو عقدةِ الفيلِ تمر الآن أمام ناظري وأقصّها، أبعدتُ هذه البكرة من الذكريات لأرى أين أنا: الدخان يملأ المكان وهناك نار…نعم، النيران تلتهمُ الستائر والزوايا و…وماذا أيضاً؟
لا أستطيع أن أرى، لا أستطيع أن أتنفس حتى، ركزي الآن، لمَ عادت بكرةُ الفيل إلى ذاكرتك مجدداً؟ لا…إنني حاضرة جداً في اللحظة؛ ماس كهربائي أدى إلى هذا الحريق وأنا وحدي في الغرفة فزميلتي في السكن الجامعي لديها موعدٌ عند طبيب الأسنان، و…وما هذا؟…إنها خراطيم فِيلة تزحفُ نحوي من النوافذ، إن أسوأ كوابيسي يتحقق.
يبدو أنني كنتُ أفتح عينيّ وأُغمضهما كل بضع دقائقَ أمام قسوة مشهد الخراطيم الزاحفة وهي ترش المياه في كل مكان مما جعل الذكرياتِ الفيليةَ تعود إلي.
“مرةً في حينا زارنا فيلٌ ظريف…برفقٍ قال لنا ليس هنالك ما يخيف…نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف…لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف…بابار فيل…ذكي نبيل”.
-النهاية-
رشا ومشروبها الغبي! لكن لم أتوقع أن يصلَ بها الأمر إلى أن تطلقَ على مشروع أول مجموعة قصصيّة لها مثل هذا العنوان الأحمق، إنه بلا شك تأثير الشاي الذي تدمنه، فكيف إن نقص رشفةً؟! بالتأكيد سيجنُّ جنونها إلى الحد الذي يجعلها تبتدعُ مثل هذا العنوان.
“قصص جميلة ولكن ما الفائدة منها؟”.
لن يتغير رأيي الذي تعبرُ عنه هذه الجملة الاستفتاحية لسجالاتي مع رشا، لن يتغير حتى وإن كنتُ فرحاً لمحاولتها بأن تثبتَ ذاتها، بأن ترمم ما ينقصها -وإن كنتُ لا أراه نقصاً-، بأن تقول ما يجول في داخلها من أفكار هي أقربُ للبوح أكثر من كونها أفكاراً تقول فائدةً وعبرة.
بوح.
أعلم أنّ المجموعة غير منتهية، هذا بديهي إذ يستحيلُ أن تكون بقصتين فحسب، ولكن أيعقلُ أن تسميَ رشا المجموعةَ باسمِ قصة غير مكتوبة بعد؟!
أنا رجل علم مخلصٌ، حسناً… فلأضع فرضيةً مفادها أنه لا يُشترط أن يكون العنوان هو عنوان قصة داخل المجموعة، إذن فلا بدّ من وجود رابط بين القصتين يصلحُ للتوحيد فيما بينهما وأيضاً بينهما وبين القصص القادمة، لكنني لا أرى أيَّ دليل يشي بأن يكون هذا الرابطُ هو الشاي، أكره أن أقول ذلك ولكن يبدو أن الأطباء لم يبتروا قدمَك فقط يا رشا في ذلك اليوم وإنما بتروا معها جزءاً كبيراً من دماغك.
صفعتني فتاةٌ جميلة بفستان لامع من الساتان الأحمر كانت قد خرجَت من الحائط المجاور لطاولة الحاسوب حيث أجلسُ، صفعة مستعجلَة وذلك قبل أن تسندَ ظهرها إلى الحائط من جديد وهي تبتسم لفلاشات الكاميرات التي تصدر….لا أدري أين هي الكاميرات التي تتولد عنها كل هذه الفلاشات المبهرة، لكنّ شفتيها تريدان أن تحلّا وثاق الابتسامة لتطلقا العنان لضحكة قوية، وهذا بالفعل ما حدث:
أشارت بيدها للكاميرات -التي يبدو أنّها غيرُ مرئية بالنسبة إليّ فقط- بأن تتوقف عن التقاط الصور، ثم تقدمت نحوي وأنا لا أزال جامداً مكاني أحاول أن أكبح جماح أفكار تتكاثر كالجراد وتفح كالأفاعي: هذه سالي التي تكره الموضة وتحب المنطق، اقتربَت أكثر وأكثر: “أنتِ سـ..سسـ..آآآآآآه”
-“هذا ما يجب أن تفعله بك كتب المنطق أيها اللا منطقي، أن تبتر قدمك أنت لا قدمَ رشا”.
ما الذي يحدث بحقّ السماء؟ لو لم تقل سالي إنها كتب منطق لما عرفتُ ممّ يتكون برجُ الكتب هذا الذي يهرسُ قدمي في هذه اللحظة.
الألم يصهر كلَّ خلية، حرارتُه ستصل إلى قلبي ودماغي وسينفجران بعد ثوانٍ لا محالة، كل هذا الحضور القوي في اللحظة الجامدة بألمها المطاطي لم يُفقدني الشعور بضحكة سالي الطفولية وكأنها تضحك على كلب فشل في التقاط كرة علقت بين أشجار عالية، أردتُ أن أفتح فمي لأفحّ كالتنين نارَ ألمي في وجهها، لكنها عاجلتني بانثناءة رشيقة من إصبعها مستدعيةً شخصاً ما من الفراغ، من العدم، بل من الحائط، لا…إنه ليس شخصاً، لربما هو شيء ما، إنه ضخم، أيُعقل أن يكون جبلاً؟ وهل للجبل ذيل؟ وهل يتسعُ حائط غرفتي لجبل أساساً؟ يبدو أنه….ما هذا؟ فيل؟!
“أعرّفك بصديقي الفيل من قصة جيم جواب”.
لم تدع لي مجالاً للاستغراب حتى، وكأن رأيي في كل ما يجري وكل ما يخرج من الحائط أو من العدم غير مهم، ليس رأيي فحسب بل وجودي كله لا يهمّها، إذ تتابع حركات الساحر مصفّقة بكفيها ليصدر الصوت الآتي:
” يقولُ إنه سيردُّ اعتباره اليوم فهو لم يعُد يستطيعُ احتمالَ كلّ هذا الظلمِ، لا أدري كيفَ قاومتُ انفجارَ سيل الضحكِ وأنا أستمعُ إلى تذمرِ أخي الصغيرِ من حصتهِ الناقصةِ دوماً من الشاي؛ الناقصة بمقدار رشفة.
أعتقدُ أنني أسعدُ أختٍ في العالمِ بسبب هذا الكائن المفرطِ في البراءةِ والعفوية، اندفاعي للنهوضِ من السرير صباحاً لا يخلقهُ أقوى منبه في العالم وإنما رغبةٌ قويةٌ في تناول طعام الإفطار معاً قبل الذهاب إلى المدرسةِ، والاستمتاعِ بيديه المعجونتين بكل ما في هذا العالم من رقةٍ وهما تحاولان أن تكونا صلبتَين قدر الإمكانِ للإمساك بكأس الشاي دون رجفةٍ تسري فيهما.
حرارةُ كأسه تظلُّ ملتهبةً في يده الصغيرة وأنا أمسكُ بها في طريقنا إلى المدرسة، فكيف سيصبحُ حالها إن هو ردَّ اعتباره وأصرّ وألحّ لملء كأسه حتى تمامِها؟
رغمَ رغبتي الشديدةِ في الضحكِ بعد سماع تذمره إلا أن خوفي من أن يتعرضَ للأذى بسبب عشقه الغريب للشاي سيطر عليّ، هل أخبرُ أمي؟ لا، ما هذا الغباء؟! هي بجانبه أساساً فهي مَن تعدُّ له الشاي صباحاً، ومساء أيضاً في أثناء ممارسة هوايته المحبَّبة إلى قلبه؛ الرسم وذلك بعد الانتهاءِ من فروضه المدرسيّةِ”.
إنه صوت رشا يصدح في كل أنحاء الغرفة؟ أهي خدعة ما أم مزحة ثقيلة؟ لا يُعقل، فهي الآن عند طبيبها المشرف على حالة ساقها…ساقها المبتورة، لا…لا، ساقها الاصطناعية، تباً لكل هذ الجنون! المهم أنها ليست هنا، ولكن هذا صوتها بالتأكيد الذي نطق بالكلمات السابقة.
التف خرطوم الفيل مجدداً حول جسدي وأنزلني أرضاً، ولكن ليس أرض الغرفة بل هو زقاق ضيق في حارة صغيرة، نعم…أستطيع أن أتذكره بوضوح، إنها حارتنا القديمة وهذا الزقاق كنا نعبره يومياً للوصول إلى المدرسة، والآن تحديداً يلوحُ من آخره فتاة وصبي يصغرها في زيّهما المدرسي، يمشيان نحونا دون أن يقطع أحاديثهما وجودُ فيل مثلاً في حارة، لا أصدق عينيّ!! إنهما رشا وأنا منذ عشر سنوات!!
لا أذكر كم مضى من الوقت على فقدي لحواسي، استيقظتُ على إصبع سالي وهو يطبقُ فكي المفتوح وكأنها بفعلها هذا قد ضغطت على زر التشغيل في جسدي المتصلب وأعادت الروح إليه، ابتسمَت بخبث لا يتناسب مع سماحة ملامحها:
لم أُكمل قولي فقد وصلنا إلى باب مدرستهِ، قبّلَ يدي بامتنانٍ ثم ركضَ نحو صديقه “شادي”، كنتُ سأخبرهُ بضرورةِ تأجيل تنفيذِ الخطة إلى الغدِ لأنني سأمضي عطلة نهاية الأسبوع عند “ندى”؛ ابنة خالتي…حسناً، سأخبرهُ في المنزل بعد العودةِ من المدرسة.
تابعتُ المشي نحو مدرستي وأنا أشعرُ بسعادةٍ غامرةٍ فقد مرّ شهر كامل على توقف سقوط القذائفِ حيثُ بيت خالتي وسأمضي عطلةً لا تُنسى من التسليةِ والسهر مع “ندى” رغم أنف الحرب، لكنّ المسبِّبَ الأكبر لهذه السعادةِ هو كوني شريكةً في خطةِ “يزن”، ثقتُه السريعة بي، وقبلتهُ اللطيفة تلك.
يتابع فيل وشخصان فوقه مسير رشا ويزن الصغيرين، هل هذه المحادثة بينهما وليدةُ خيال رشا أم أنها بالفعل قد حصلت؟ من المؤكَّد أنها مختلَقة فالشاي هو مشروب رشا، ولا يُعقل أن أكون أنا المدمن كما يحاول عقل رشا سرده الآن.
هاج الفيل هنا رافعاً قائمتيه الأماميتين، التقت عيناه في رأسه المقلوب بعينيّ فابتسم بخبث يشبه خبث سالي ثم لف جسدي بخرطومه مجدداً قبل أن يقذفني في السماء بعيداً:
“سوف أتأخرُ، لا بدّ من الذهابِ إلى بيت خالتي قبل أن يحلَّ الظلامُ لكن “يزن” لم يعد وإنما ظلّ يلعبُ في بيت “شادي”، ماذا أفعل الآن؟ كيف أخبرهُ بحالة الطوارئ التي خضعت لها خطتنا؟ لا أريدُ أن أخذلَ قلبه الصغير الجميلَ لكن ما باليد حيلة ويجب أن أنبّه أمي إلى ما سيفعله اليوم.
ضحكت أمي عندما سمعت بأمر الخطةِ، وتوصّلنا إلى اتفاق سريٍّ يقضي بضرورةِ مراقبته جيداً كي لا يعدّ الشاي بنفسهِ ولكن مع جعلهِ يشرب كأس شاي ممتلئةً دون أية قطرة ناقصةٍ حتى.
شريطُ الأخبار العاجلةِ الأحمرُ فجّر كل الدماء الحمراء في كل خلية من خلايا جسمي فركضتُ كالمجنونةِ من بيت خالتي إلى حيّنا الذي أمطرته القذائفُ، يا إلهي! لا أستطيع التعرفَ إلى منزلي وسط بحر الأنقاضِ هذا، بقيتُ أركضُ مسعورةً رغم محاولاتٍ لأيادٍ غريبة بتطويقي، وذلك دون أن تكفّ حنجرتي عن الصراخ باسم “يزن”، توقفتُ فجأة، شعرتُ بمعنى الموتِ للحظات معدودةٍ قبل العودة إلى الحياة من جديد؛ رأيتُ فوق تلك الزاوية من الركامِ ورقةً بيضاء مرسوم عليها، وملطَّخة ببقعة شاي.
إنها أول خطة فاشلةٍ تكتب النجاةَ لصاحبها، يزن يتنفس…يتنفس”
هبطتُ بهدوء على دمار يحيطُ بي من كل جانب، كان صوتُ رشا الذي يسرد القصة قد اختفى، هل هي فاصلة جعلتها تستريح قليلاً أم هي تلك الفاصلة الأخرى؟ ما اسمها؟ نعم… اسمها فاصلة منقوطة، أيعقل أنها نقطة؟! لا، مستحيل أن تنتهي قصة رشا هنا فالأحداث لم تنته بعد، أو بالأحرى فإن هناك تحريفاً كبيراً فيها؛ أنا لا أحب الشاي، لا أرسم، إضافة إلى أن رشا كانت في المنزل عندما أطاحت القذيفة بأركانه كلها وتسببت بموت والدَينا وبتر ساقها لأكون أنا الناجي الوحيد.
أرى الآن رشا تضم يزن الصغيرَ إلى صدرها وهي تبكي وتضحك في الوقت نفسه، تنظر إليه بفزع، تقربُ أذنها من أنفه وفمه، تمسحُ دموعها ثم تنهض وتحمله بين ذراعيها وتمشي بصعوبة فوق الأنقاض، كل ذلك وهي تصرخ دون صوت وإنما أستطيع أن أفهم حركة شفتيها: “يزن يتنفس…يتنفس”.
تمشي متعثرة ولكن بعناد، طفلة تحملُ طفلاً بقوة ألف رجل، تصل إلى سيارتَي إسعاف تغصان بالجرحى، لا يوجد صوت إلا أن حركاتِ رأس المسعف ويدِه تقول إن عليها أن تنتظر ريثما يتم نقل المصابين وإن السيارتين ستعودان من أجل أخيها وغيره، يصرخ مُسعف من السيارة الأخرى التي ابتعدت قليلاً -صراخه دون صوت طبعاً- بما معناه أن هناك متسعاً لمصاب أو اثنين، تبتسمُ رشا رغم أنفاسها المتقطعة التي لا تعير لها بالاً وإنما تسرع نحو باب السيارة كي تصلَ بيزن الصغير إلى بر الأمان، يحمله المسعف قبل أن تدوي عاصفة قصيرة من الرصاص التي ثقبت الهواء فجأةً، الساق التي ركضَت يثنيها وزنُ الجسد الصغير قد اخترقتها رصاصتان طائشتان، واليدان الصغيرتان اللتان انزاح عنهما ثقل الجسد أشارتا لسيارة الإسعاف أن تنطلق بسرعة قبل أن تنهارا ….
لماذا كذبتِ عليّ يا رشا؟ أنا السبب، أنا من بتر لك ساقك، رشفة الشاي تلك التي دلت على مكاني دمّرت حياتك، وستدمر حياتي الآن بعد أن علمتُ الحقيقة.