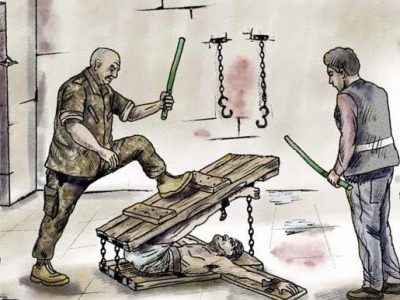القصة الفائزة بالمركز الثالث لمسابقة أبجد بدورتها الثالثة
لم يكن عبثًا الدّوار الذي أصابني، فأمّي كانت كثيرًا ما تدور في فترةِ حملها حول وردةٍ نديّةٍ، زَرَعَتْها وسط دارنا احتفالًا بنبأ حملها بي.
والغريب أنّني لمْ أصرخ أو أبكي كما كلّ الأطفال عندما شهقتُ للحياة، و الأغرب من ذلك، حين قرّبني والدي إليه ليهمسَ باسم ِاللهَ في مسمعي كما جرت العادة؛ سقطت من عينه دمعة في أذني فابتسمت!
مرّت الأعوام، وظللْتُ على هذا الابتسام، و لم أعرف البكاء يومًا، و لم يعرف طريقه إلى عينيّ، و عُرِفتُ: “بذات الهدوء الغريب”.
كانت المعلّمة تناديني بالهادئة، حتى أصدقائي في المدرسة، في البيت، في اجتماعات الأقارب والجيران، و في كلّ مكان.
لا أنكر أنّني صرتُ أنزعج من هذا اللّقب، لأنّه يغطّي على صفاتي الأُخرى، حتى أنّني لا أستطيع أن أُخبرهم بتلك الميزة الفريدة، و لم يعرفوا ما أخبّئه في تلافيف دماغي.
فكلّما أُفكّر مليًّا بفكرة أو أسمع صوتاً بعيدًا قادمًا من أعماق أحد؛ أحسّ أنّ الدمعة ترتجف و تترقرق في رأسي، ليس هذا فحسب؛ بل يخرج ضوءًا خافتًا من جهة أذني!
أتعبتني فكرةُ أن أحرص على: (ألّا أُظهِر شعوري) بل أبقى صلبةً كالصّخر، لا ألتفت، بل أتّبع وصيّة والدي في دمعته.
كل ّ ذلك، و مازال الأمر على ما يُرام، إلى أن صرتُ أسمع الأصوات البعيدة جدًّا و التّي تتحدّث بسوء، و صار النّاس يغالون في الاستفزاز عن قرب لاختبار صبري و قدرة تحمّلي ظنًّا منهم أنّني متلبّدة الشّعور.
أخذت الكلمات المزعجة تثقب ذهني كالمسامير، فلم تعد تنبُت الورود، بل استحالت لأشواك صفراء يابسة.
ساءت حالتي، ولوحِظَت جروحٌ تسيل من رأسي، و تحوّلت الماسات إلى حصى صغيرة تتحرّك، تجرح، و تحرق مكانها، فتتشبث أكثر، عند كلّ قلقٍ أو خوفٍ، أو حزن، كما اختفت هالة الضّوء التي كانت تومض من أذني!
وفي يومٍ ليس ببعيد، لا أدري ما الّذي أصابني جرّاء صدمة، أشبه بزلزالٍ جسديّ، عاصفة غريبة اجتاحتني، بل إعصار دهليزي، حرّك تلك الحصى.
فكلّما تجاوزتُ عن إزعاجٍ ما، سقط حجرٌ ملوّنٌ بدل الدّموع: “أخضر زّمرّدي، أحمر ياقوتيّ، و الأزرق الفيروزيّ”.